সাম্প্রতিক আপডেট
سُنَنُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالصَّحَابَةِ
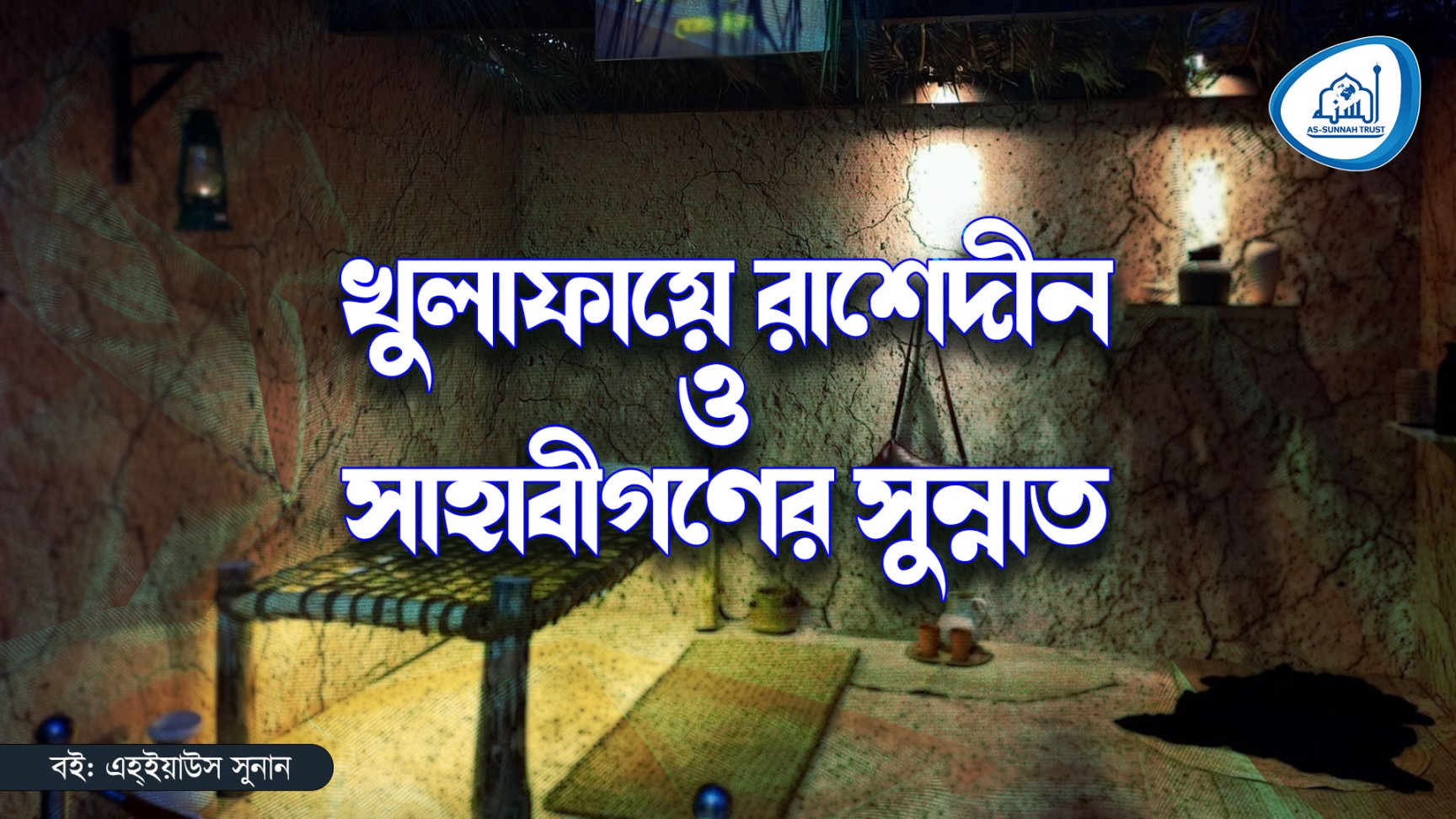
ثانياً: سُنَنُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالصَّحَابَةِ
(١) اتباعُ الصحابة: اختلافُ الأئمَّة
لقد بشَّر الله تعالى في القرآن الكريم جميعَ الصحابة قبل فتح مكة
وبعده بالجنَّة.﴿سورة الحديد: ١٠، سورة الأنبياء: ١٠١-١٠٤﴾. وقال عن
الأُمم اللاحقة إنهم يُحبُّون جميعَ المهاجرين والأنصار بقلوبٍ صافية ويدعون لهم.
﴿سورة الحشر: ٧-١٠﴾. وقد نهى رسول الله ﷺ في أحاديث كثيرة عن سبِّهم، وجعلهم
جميعاً محلَّ تكريمٍ ومحبةٍ لهذه الأُمَّة.[صحيح البخاري، كتاب المناقب، حديث
٣٦٧٣؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، حديث ٢٥٤٠].
وقد أجمع جميعُ الأئمَّة والعلماء المتَّبَعين للأُمَّة، أي أئمَّة أهل
السُّنَّة والجماعة، على وجوب محبَّة الصحابة كلِّهم، وتحريم بُغضِ أحدٍ منهم أو
سبِّه مطلقاً. وإنَّ تعظيمَهم ومحبَّتهم من تعظيم رسول الله ﷺ.
وفي كتاب العقيدة المشهور لأهل السنَّة "الفِقْه الأكبر" قال
الإمام أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ) : «لا نذكرُ أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ إلا بخير] ». شرح الفقه الأكبر لملا علي
القاري، ص ١٠١. [
وقال الأئمَّة من بعده مثل ذلك: إنَّ سبَّ أحدٍ من الصحابة، أو اعتقادَ
شرٍّ فيهم ولو قليلاً، أو انتقاصَهم، هو مخالفةٌ للقرآن والسُّنَّة، بل كراهيةٌ
لسُنَّة رسول الله ﷺ نفسه. [انظر: الطبري (ت ٣١٠هـ) "صريح
السُّنَّة" ص ٢٣-٢٤؛ الطحاوي (ت ٣٢١هـ) وشرح ابن أبي العز الحنفي (ت ٧٩٢هـ) ص
٤٦٧-٤٧١؛ ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت ٣٨٦هـ) "المقدمة القيروانية"
ص ٧٥؛ ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ) "الدُّرَّة" ص ٢٢٨، ٣٦٣-٣٦٩؛ البيهقي
الشافعي (ت ٤٥٨هـ) "الاعتقاد" ص ٣١٧-٣٢٣؛ الغزالي (ت ٥٠٥هـ)
"الاقتصاد في الاعتقاد" ص ١٥٢-١٥٤].
لكن اختلف الفقهاء والأئمَّة في مسألة: هل أقوال الخلفاء الراشدين
وأفعال الصحابة حُجَّة شرعية أو قدوة واجبة الاتِّباع؟
اتَّفقوا جميعاً على أنه حيث وُجِد في القرآن أو السنة نصٌّ صريح، فلا
اعتبارَ بعده لقول الصحابة أو فعلهم. ولكن عند عدم وجود نصٍّ نبوي، وقع الخلاف:
فالإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) وبعض الأئمَّة
أنكروا بشدة أن يكون قولُ الصحابي أو فعلُه حُجَّة شرعية، وقالوا: إنما الحُجَّة
في القرآن والسنة فقط، فإذا لم يوجد نصٌّ فيهما فالمرجع إلى الإجماع أو القياس.
وأفضلُ الإجماع: إجماعُ الصحابة.
وأما آحادُ أقوال الصحابة أو أفعالهم فلا
تكون أبداً قدوة مُلزِمة. بدليل أننا لا نأخذ بكل أقوالهم؛ فقد قال بعضُ الصحابة
بجواز أكل البَرَد (الثلج النازل مع المطر) في حال الصوم، وقال بعضهم بجواز الربا
في النقد الحاضر مع التفاضل، وقال بعضهم بجواز النكاح المؤقَّت (المتعة). فكيف
يُجعَل كلُّ ما فعلوه سُنَّة؟
الذين يعتبرون أقوالَ الصحابة وأفعالَهم
قدوةً مُلزِمةً، فقد انتقدهم الإمام الغزالي (ت ٥٠٥هـ) بِلُغةٍ شديدةٍ وذمَّهم.
ورأيه ورأي غيره من علماء الشافعية أن الصحابة كسائر البشر؛ قد تقع منهم الأخطاء،
وقد يجهلون بعض الأحكام. ولذلك لا يجوز اعتبارهم قدوةً مُطلَقةً أو أسوةً واجبة
الاتِّباع. وعند عدم وجود سنَّة نبوية صريحة يجب الرجوع إلى القياس.
وعلى الجانب الآخر، فإن الإمام أبا حنيفة (ت
١٥٠هـ) والإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) وأتباعهما وكثيراً من العلماء ذهبوا إلى
أنه إذا لم يوجد نصٌّ صريحٌ في السُّنَّة النبوية، ثم أجمعت الصحابة على رأيٍ ما،
أو قال به بعضهم ولم يعارضه الآخرون، فإن قول الصحابي أو فعله يكون حُجَّةً
ويُتَّبع. وقالوا: مع أن الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، إلا أن القرآن والحديث
قد كرَّرا بيانَ فضلهم وكمالَ منزلتهم، وأُمرنا باتِّباعهم. وهذا الاتباع ليس في
سنَّة النبي ﷺ فقط، بل في بيانهم وتفسيرهم لها أيضاً.
وقالوا: إذا لم يكن هناك نصٌّ نبويٌّ، فإن
رأي الصحابي أو عمله إمَّا أن يكون مستنداً إلى حديثٍ عن رسول الله ﷺ، وإمَّا أن
يكون اجتهاداً شخصياً منه. وحتى لو كان اجتهاداً شخصياً، فإن كونه عاش في صحبة
النبي ﷺ، ومعرفته التامَّة بلغة العرب، وإحاطته بسياق القرآن والحديث، يجعل رأيه
أقرب إلى الصواب من آراء الأئمة الذين جاءوا بعدهم. ولذلك كان اتباعُهم واجباً. [انظر:
السرخسي، المحرَّر في أصول الفقه ٢/٨١-٩١؛
الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، المستصفى ١/٦١٦-٦٢٦؛
علاء الدين البخاري (ت ٧٣٠هـ)، كشف
الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٤٠٦-٤٢٢؛ محمد بن حسين
الجيزاني، معالم أصول الفقه ص ٢٢٢-٢٢٧[.
وبناءً على النصوص القرآنية والحديثية
والأدلَّة العقلية، نرى أن هذا القول هو الأصح. فنعتقد أن سُنَّة الصحابة، وخاصةً
الخلفاء الراشدين، تُعتبر جزءاً من السنة النبوية وتفسيراً لها. ولذلك سنتناول في
هذا الكتاب سننَهم باعتبارها من السُّنَّة النبوية نفسها.
(٢) سُنَّة الخلفاء الراشدين: التعريف والمجال
لقد رأينا أن رسول الله ﷺ نفسُه أعطى الحقَّ
للخلفاء الراشدين أن يُجروا سنناً. فهل كانوا يضعون سنناً من عند أنفسهم؟ كلا،
أبداً. بل لم يخرجوا قطُّ عن سُنَّته ﷺ.
فقد قال أبو بكر رضي الله عنه في أول خُطبةٍ
له بعد أن بويع بالخلافة: «قد وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيركم، وقد أنزل الله القرآن، وعلَّمنا رسول
الله ﷺ السنن، فتعلَّمناها... ألا فاعلموا: )إِنَّمَا أَنَا
مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ( إنما أنا تابعٌ (لسنَّة رسول الله ﷺ)
ولستُ مُحدِثاً ولا مُبتدِعاً. فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن زُغتُ فقوموني».[ابن
سعد، الطبقات الكبرى ٣/١٣٦[.
وهكذا نرى أنهم كانوا لا يساومون في اتباع
السُّنَّة. ولكن لماذا أمر رسول الله ﷺ باتباع سُنَّتهم على وجه الخصوص؟
فسَّر العلماء ذلك على وجهين:
أولاً: إنهم كانوا الأعلم بفهم السُّنَّة.
فقد كانوا أعلم الناس بسبب فعل النبي ﷺ أو تركه، لأنهم عاشوا معه طول حياتهم، من
بداية دعوته إلى وفاته ﷺ، وكانوا ملازمين له دائماً، عارفين بجميع أوامره ونواهيه،
وقد تنوَّرت قلوبهم بنوره. لذلك كانوا أقدر الناس على إدراك ما إذا كان يجوز فعل
ما تركه النبي ﷺ في بعض الأحوال، أو ترك ما فعله في حالات أخرى. فكان اعتبارهم في
تطبيق السُّنَّة النبوية هو الأمثل، ولهذا أمر النبي ﷺ خاصةً باتباع سُنَّتهم.
ثانياً: إن جميع طرق السير إلى الله تعالى
ووسائل نيل قربه قد علَّمها رسول الله ﷺ. ولكن مع تغيُّر الأزمنة ستظهر مشكلات
جديدة لم تكن في عهده ﷺ. ففي هذه الأمور نسترشد بسُنَّة الخلفاء الراشدين وطرائقهم
في اتخاذ القرارات على ضوء تعاليمه ﷺ. ففي أمور الجهاد، وسياسة الدولة، وحفظ الأمن
والنظام، ومكافحة الجرائم المستحدثة وأساليبها، وتنفيذ العدل، وحماية إقامة
العبادات إذا عرضت لها عقبات – كانت سُنَّتهم هي القدوة للأمة.
(أ) سُنَّة أبي بكر رضي الله عنه: قتال المرتدين وجمع القرآن
في عهد أبي بكر رضي الله عنه ظهرت طائفة امتنعت عن دفع
الزكاة، وكانت مشكلة جديدة. فقرَّر على ضوء السُّنَّة قتالهم، وهذا عندنا سُنَّة
وحكم شرعي. وكذلك كل طائفة في أي مجتمع ترفض الزكاة أو حكماً ضرورياً مماثلاً،
فعلى الدولة أن تقاتلهم.
وفي زمانه استُشهد كثير من حَفَظَة القرآن
من الصحابة، فخيف ضياع شيءٍ من القرآن. فقام بجمع الصحف والسور التي تركها رسول
الله ﷺ على هيئتها، وأمر بربطها لتكون مصحفاً واحداً. كما أنه شدَّد في رواية
الحديث، فأمر بأخذ الشهادة عند الرواية حتى لا يدخل الكذب أو الخطأ، وهذا من
السُّنَّة كذلك.
(ب) سُنن عمر رضي الله عنه في سياسة الدولة
في
عهده اتسعت الدولة الإسلامية في المساحة، فشرع عدداً من النظم لتنظيم شؤونها. فوضع
تاريخ الهجرة للتقويم، وولَّى القضاة في الأمصار، وأنشأ الدواوين لتنظيم الإدارة،
وأقام البريد. وعيَّن مقادير بعض الحدود والعقوبات وفق تعليمات الرسول ﷺ.
وكان النبي ﷺ يواظب على صلاة الليل ويحض على
أدائها في رمضان، وقد صلاها بالجماعة عدة ليالٍ ثم تركها خشية أن تُفرض. فقام عمر
رضي الله عنه بجمع الناس عليها جماعةً بانتظام، فكان ذلك سُنَّةً شرعيةً أيضاً.
(ج) سُنَّة عثمان وعلي رضي الله عنهما: نشر القرآن، وضع الحركات، وتقعيد النحو قام عثمان رضي الله عنه
بنسخ المصحف الذي جُمع
في عهد أبي بكر، ونشره في الأمصار، ليُتلى القرآن على هيئة ما أُنزل بلا اختلاف.
وقام علي رضي الله عنه بوضع علامات الإعراب في المصحف، ووضع أسس النحو وتعليمه،
ليحسن المسلمون تلاوة القرآن ويفهموا معناه على وجهه الصحيح.
كل هذا من سُنَّتهم، وعلى الأمة أن تتبعها
في هذه الأمور. وفي المشكلات الجديدة يجب أن يُجتهد على ضوء سُنَّتهم. [انظر:
ابن سعد، الطبقات الكبرى ٣/١٣-٢٩،
١٢٥-١٦٠، ٢٠١-٢٨٦؛ ابن كثير، البداية والنهاية ٥/٣-٤٩٧؛ ابن العماد، شذرات الذهب ١/١٤-٥٢؛ الإمام مالك، الموطأ ٢/٥١٣؛ ابن حجر
العسقلاني، فتح الباري ١٢/٢٤٧؛ البيهقي، السنن
الكبرى ٤/٢٩٨؛ كذلك: صحيح مسلم ٣/١٣١١،
حديث ١٦٨٣؛ سنن الترمذي ٢/٢٥٧-٢٥٨، حديث ٤٠٦[.
(غ) الأذان الأول لصلاة الجمعة
لقد رأينا أن الصحابة الكرام كانوا
يُعظِّمون سُنَنَ الخلفاء الراشدين غاية التعظيم، ومع ذلك إذا رأوا أن في فعلهم ما
يظهر أنه مخالفٌ لهيئة عمل النبي ﷺ تردَّدوا في قبوله. والحق أنهم لم يخرجوا قط عن
سُنَّة رسول الله ﷺ، بل كانوا أدقَّ الناس في اتباعها في العبادات والشعائر. ولكن
في ضوء سُنَّته ﷺ اضطروا أحياناً إلى زيادة بعض الوسائل أو الوسائط لتحقيق مقاصد
العبادة. ومن ذلك مسألة الأذان يوم الجمعة.
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ النِّدَاءُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمَّا كَانَ
عُثْمَانُ رضي الله عنه وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى
الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ».
وفي رواية ابن ماجه: «فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ
النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا
الزَّوْرَاءُ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ». ]وفي
رواية أبي داود زيادة: «بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ... عَلَى بَابِ
الْمَسْجِدِ»، وفي سندها ابن إسحاق وهو ثقة مُدلِّس قد عنعن، فلذا في صحتها نظر،
وقد روى أحمد رواية ابن إسحاق هذه وفيها التصريح بالسماع ولكن ليس فيها هذه
الزيادة[.
قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: كان
الأذان يوم الجمعة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أذاناً واحداً،
حين يجلس الإمام على المنبر. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد أذاناً
آخر، وكان في موضع بالسوق يقال له الزوراء. فاستمر الأمر على ذلك.
وهكذا نرى أن عثمان رضي الله عنه زاد أذاناً
لم يكن في عهد النبي ﷺ. ولماذا فعل ذلك؟ لأنه كان قد عاشر النبي ﷺ وعرف سُنَّته عن
قرب، وفهم أن الأذان وسيلة لإعلام الناس بالصلاة. وخطبة الجمعة واجبة على المسلمين
سماعها. وفي عهد النبي ﷺ كانت المدينة صغيرة، والبيوت حول المسجد، فكان الناس
يحضرون قبل الوقت أو مع الأذان مباشرة، فلا تفوتهم الخطبة. لكن في عهد عثمان رضي
الله عنه توسعت المدينة وكثر الناس، فلو اكتفى بأذانٍ واحد لفات كثير من المسلمين
سماع الخطبة. فشرع الأذان الأول في السوق ليتمكن الناس من الحضور مبكراً، فينالوا
سُنَّة سماع الخطبة.
وهذا الحق في بيان السُّنَّة وتطبيقها إنما
هو للخلفاء الراشدين وحدهم. فلو أحدث أحد غيرهم زيادة في الأذان لما قُبلت. أما
عثمان رضي الله عنه فقد أقرَّه الصحابة الموجودون في عصره، وقبلوا فعله. ومع ذلك
فقد كان لبعض الصحابة والتابعين تحفظ على الأذان الأول، إذ كان سُنَّة النبي ﷺ
أعظم عندهم. فمع كون سُنَّة الخلفاء الراشدين حُجَّةً، تردد بعضهم في قبوله. وكان
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «هذه زيادة في الأذان بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وإن رآها الناس حسنة».
ولا شك أن هذا رأيٌ شخصي لابن عمر رضي الله
عنهما، وهو كصحابي يجوز له أن يُخالف صحابياً آخر. أما نحن فلا يجوز لنا في القرون
اللاحقة أن نصف عمل أحد الخلفاء الراشدين بالبدعة، لأن النبي ﷺ نفسه سمَّى عملهم
سُنَّةً وأمر باتباعها.
كتاب: إحياءالسنن، للأستاذ الدكتور خوندكر عبد الله جاهنغير
رحمه الله
কপিরাইট স্বত্ব © ২০২৫ আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট - সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত| Design & Developed By Biz IT BD
