সাম্প্রতিক আপডেট
سند الحديث: السرد الشفوي مقابل الاعتماد على المخطوطات
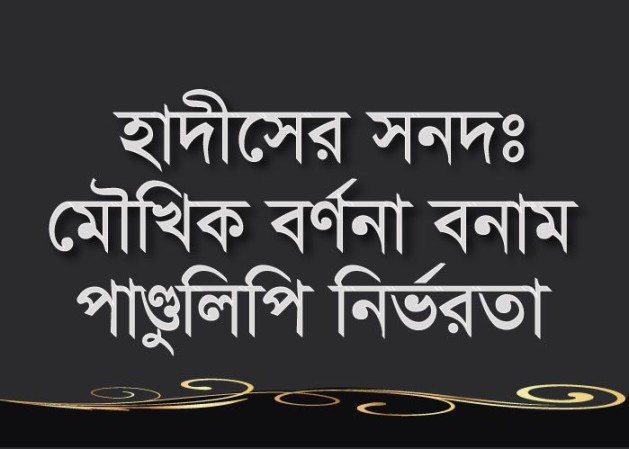
سند الحديث: السرد الشفوي مقابل الاعتماد على المخطوطات
الدكتور خُندَكَار أ.ن.م. عبد الله جاهنغير (رحمه الله)، أستاذ، قسم الحديث والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية، كُشتيا
وبناءً على هذه التوجيهات، شدّد الصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث وقبوله على التحقق من صحته ودقته، واتبعوا في ذلك منهجًا علميًا دقيقًا لا مثيل له في التاريخ. فلم يعرف التاريخ أن أمة أو جماعة دينية قد اتبعت مثل هذا الحذر والدقة في جمع وحفظ كتابها المقدس أو أقوال نبيها.
واقتداءً بسيرة الصحابة، واصل المحدثون من أمة الإسلام لعدة قرون التحقق من صحة الحديث ودقته اللفظية باستخدام منهج علمي دقيق. ولكن في العصر الحاضر، يجهل كثير من الناس هذا المنهج النقدي والتحقيقي، مما أدى إلى وجود الكثير من الغموض واللبس حوله.
ويظن بعض المستشرقين وبعض المثقفين المحليين أن الأحاديث — لما كانت منقولة مشافهة عن طريق سلسلة الرواة — فهي مليئة بالأخطاء، فلا يُعتمد عليها، ويجب الاعتماد على القرآن الكريم فقط لمعرفة أحكام الإسلام. وهذه الشبهات إنما نشأت بسبب الجهل بمنهج المحدثين الدقيق والعلمي في التحقق من صحة الأحاديث.
وفي هذه المقالة سنناقش دور الكتابة والمخطوطات في رواية الحديث وتوثيقه. ونسأل الله تعالى التوفيق ونعتمد على رحمته وحده.
فعلى سبيل المثال، الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، أحد كبار المحدثين في القرن الثاني الهجري، ذكر أسماء ٣ أو ٤ رواة بينه وبين النبي ﷺ في كتابه "الموطأ".
مثال على ذلك:
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله ﷺ بيده يقللها.
ففي مصطلح المحدثين، لا يُقصد بـ"الحديث" المتن وحده، بل الحديث يشمل السند والمتن معًا. وإذا ورد نفس المتن بسندين مختلفين، يُعتبر حديثين مختلفين.
ومن هذا نرى أن الدارقطني عنى بـ"الحديث" السند فقط.
٢.٣. رواية السند: السماع الشفهي مقابل الاعتماد على المخطوطات
من خلال الحديث المذكور أعلاه والعديد من الأحاديث المماثلة المجمعة في كتب الحديث، قد يظن البعض أن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لم يقوموا بتدوين الأحاديث، بل كانوا يروونها شفوياً فقط. قد يكون هذا هو السبب في قيام المحدثين بذكر السند عند جمع الأحاديث. لكن الأمر ليس كذلك. إن الجهل أو الفهم السطحي لأساليب رواية وجمع الحديث هو ما أدى إلى هذا الالتباس. في الواقع، اتبع المحدثون في الأمة الإسلامية أساليب علمية دقيقة في رواية وجمع الحديث، حيث جمعوا بين الرواية الشفوية والتدوين الكتابي لمنع الأخطاء. سنناقش هذا الموضوع في ثلاث مراحل:
-
دور الكتابة والمخطوطات في تعلم وجمع الحديث.
-
دور المخطوطات في تحديد صحة الحديث.
-
دور المخطوطات أو الكتب في رواية السند.
٣. دور الكتابة والمخطوطات في تعلم وجمع الحديث
كان الصحابة عادةً يحفظون الأحاديث، وأحياناً كانوا يكتبونها. ومن الجدير بالذكر أن الحاجة لتدوين الأحاديث لم تكن كبيرة بالنسبة لهم، حيث أن معظم الصحابة لم يرووا أكثر من 20 إلى 30 حديثاً. عدد الصحابة الذين رووا الأحاديث حوالي 1500، ومن بينهم فقط 38 صحابياً رووا أكثر من 100 حديث، و7 فقط رووا أكثر من 1000 حديث. بقية الصحابة رووا ما بين حديث واحد إلى 30 حديثاً.
كانت حياتهم مكرسة لاتباع النبي ﷺ، وتذكر كلماته وأفعاله، لذا لم تكن هناك حاجة ملحة لتدوين الأحاديث. ومع ذلك، قام العديد من الصحابة بتدوين الأحاديث وحفظ المخطوطات.
منذ عهد التابعين، أصبح حفظ المخطوطات جزءاً لا يتجزأ من عملية تعلم الحديث. كان معظم التابعين والمحدثين في العصور اللاحقة يستمعون إلى الحديث، يتعلمونه، يكتبونه، ويحفظونه. عند رواية الحديث أو تعليمه، لم يكتفوا بالرواية الشفوية، بل كانوا يستخدمون المخطوطات أيضاً. كان الطلاب يكتبون الأحاديث أثناء الاستماع، ثم يقارنونها مع مخطوطات أساتذتهم. منذ نهاية القرن الأول الهجري، أصبح تدوين الأحاديث جزءاً أساسياً من نظام التعليم الحديثي.
هناك العديد من الروايات التي توثق هذا الأمر، نذكر منها:
-
قال التابعي عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب (توفي 140 هـ):
"كنت أذهب أنا وأبو جعفر إلى جابر بن عبد الله ومعنا ألواح صغار نكتب فيها الحديث."
-
قال التابعي سعيد بن جبير (توفي 95 هـ):
"كنت أكتب عند ابن عباس، فإذا امتلأت الصحيفة أخذت نعلي فكتبت فيها حتى تمتلئ."
-
قال التابعي عامر بن شراحيل الشعبي (توفي 102 هـ):
"اكتبوا ما سمعتم مني ولو على جدار."
-
قال التابعي أبو قلابة عبد الله بن زيد (توفي 104 هـ):
"الكتابة أحب إلي من النسيان."
-
قال التابعي الحسن البصري (توفي 110 هـ):
"إن لنا كتباً نتعاهدها."
-
قال التابعي الكبير عبد الله بن المبارك (توفي 181 هـ):
"لولا الكتاب لما حفظنا."
توجد العديد من الروايات الأخرى التي تؤكد أهمية التدوين في حفظ الحديث.
من هذا، نرى أن المحدثين منذ عهد التابعين كانوا يكتبون الأحاديث أثناء تعلمها. عند تعليم الحديث، كان التابعون وتابعو التابعين يقرؤون من المخطوطات أو من الحفظ، لكنهم كانوا يحتفظون بالمخطوطات للرجوع إليها عند الحاجة.
٣. دور الكتابة والمخطوطات في تحديد صحة الحديث
٣.١. معيار صحة الحديث: منهج المحدثين
منذ عهد الصحابة، اعتمد علماء الأمة الإسلامية على عنصرين أساسيين في التحقق من صحة الحديث ودقته وسلامته:
٣.٢. التحقق من دقة الرواية عن طريق الفحص المقارن
-
استجواب الراوي بأسئلة مختلفة للتحقق من دقة معلوماته.
-
عرض الحديث على الشيخ الذي زُعِمَ أن الحديث قد سمع منه للتحقق من صحة الرواية.
-
مقارنة روايات الطلاب الآخرين عن ذلك الشيخ.
-
مقارنة روايات الطلاب الآخرين لسائر الرواة في الإسناد حتى الصحابي.
-
مقارنة روايات الراوي في أوقات مختلفة.
-
مقارنة ما في الذاكرة والسماع بما هو مكتوب في المخطوطات.
-
تمييز الرواة الذين يعتمدون فقط على الحفظ أو فقط على الكتابة.
٣.٣. مقارنة بين الحفظ والكتابة (النسخ)
📚 [الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ)، الكفاية في علم الرواية، المدينة المنورة: المكتبة العلمية، ص ١١٧]
٢. قال الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك (١٨١ هـ):
٣. اجتمع في القرن الثالث كلٌّ من:
٤. قال الإمام عبد الرحمن ibn ʿUmar al‐Isfahānī Rustah (٢٥٠ هـ):
٥. قال سليمان ibn Harb (٢٢٤ هـ):
٦. سُئل الإمام Aḥmad ibn Ḥanbal (٢٤١ هـ): “هل Abū Walīd ثقة تمام الثقة؟”
7. قال الإخباريّ I‘yākūb ibn Humayd ibn Kāṣib (٢٤٠ هـ)، ونقل عن الإمام Abū Dāwūd (٢٧٥ هـ):
8. ذكر الإمام أبو أحمد ‘عبد الله ibn ‘Adī (٣٦٥ هـ):
٣.٤.١. ضعف الرواة المعتمدين على الحفظ:
في عصر التابعين وما بعده، كان هناك بعض المحدثين الذين كانوا يحفظون الأحاديث ويروونها دون الاعتماد على الكتابة. وقد ثبت أن معظمهم كانوا ضعفاء في رواية الحديث، حيث أظهر التحقيق المقارن أنهم كانوا يخطئون في الرواية بسبب عدم اعتمادهم على الكتابة. ففي الحقيقة، لا يمكن الاعتماد على الرواية إلا من خلال الجمع بين السماع والحفظ والكتابة. لذلك، اعتبر المحدثون الرواة الذين يعتمدون فقط على الحفظ أو فقط على الكتابة ضعفاء أو غير موثوقين، حيث تظهر الأخطاء والاضطرابات في رواياتهم من خلال التحقيق المقارن. نجد العديد من هذه الأمثلة في كتب الرجال والجرح والتعديل. وفيما يلي بعض الأمثلة:
-
عكرمة بن عمار العجلي (ت ١٦٠ هـ): كان حافظًا مشهورًا، لكنه لم يكن لديه كتاب يعتمد عليه، مما أدى إلى وجود اضطراب في حديثه. قال الإمام البخاري: "لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه" .
جرير بن حازم بن زيد (ت ١٧٠ هـ): قال ابن حجر العسقلاني: "ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه" .
-
عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز (ت ١٧٠ هـ): كان كثير الغلط في حديثه لأنه احترقت كتبه، فكان يحدث من حفظه .
-
عبد الله بن لهيعة بن عقبة (ت ١٧٤ هـ): قال الحاكم النيسابوري: "لم يقصد الكذب، وإنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ" .
-
حاجب بن سليمان المنبجي (ت ٢٦٥ هـ): قال الدارقطني: "كان يحدث من حفظه، ولم يكن له كتاب، وهم في حديثه" .
-
محمد بن إبراهيم بن مسلم، أبو أمية (ت ٢٧٣ هـ): قال ابن حبان: "كان من الثقات، دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا بما حدث من كتابه" .
ومن هذا يتبين لنا أنه منذ القرن الثاني الهجري، كان الحفاظ على صحة تلقي الحديث وتعليمه يعتمد على الجمع بين السماع الشفهي من الشيخ وحفظ النسخة الخطية ومراجعتها. فالحفّاظ المشهورون الذين قضوا حياتهم في تعلم الحديث وتعليمه وحفظوا مئات الآلاف من الأحاديث، لم يكونوا يدرّسون الحديث أو يروونه دون الرجوع إلى مخطوطاتهم.
ومن أبرز محدثي القرن الثالث، قال علي بن المديني (ت ٢٣٤ هـ):«ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، إنه لا يحدث إلا من كتابه، ولنا فيه أُسوةٌ حسنة.»[أبو نُعيم الأصبهاني، حلية الأولياء (بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ) ٩/١٦٥؛الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي (الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٣هـ) ٢/١٣؛الذهبي، سير أعلام النبلاء ١١/٢١٣].ومن جانبه قال الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ):«قد سمعنا من قوم حديثهم من حفظهم، وسمعنا من قوم يقرؤون من كتابهم؛ فكان الذين يقرؤون من كتابهم أصح حديثاً.»[ابن رجب، شرح علل الترمذي، ص ٥٧].ومن خلال هذا كله، يتضح أن المحدثين منذ القرن الثاني الهجري كانوا يعتبرون الجمع بين ثلاثة أمور أساساً ضرورياً في تعلم الحديث:١) سماع الحديث لفظاً من الشيخ أو عرضه عليه،٢) كتابته باليد،٣) مقابلة النسخة المكتوبة مع نسخة الشيخ ومراجعتها.وكانوا يرفضون قبول الحديث من محدث يدرّس الأحاديث من حفظه دون الرجوع إلى كتاب.قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ):
قال يحيى بن معين: قال لي عبد الرزاق: أُكتب عني ولو حديثاً واحداً من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفاً.[أحمد بن حنبل، المسند (القاهرة: مؤسسة قرطبة، ودار المعارف، ١٩٥٨م) ٣/٢٩٧؛الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي ٢/١٢].ويُلاحظ هنا أن الإمام يحيى بن معين (ت ٢٣٣ هـ) لم يرضَ أن يروي حديثاً واحداً حتى من مثل الإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١ هـ) — وهو من كبار المحدثين الثقات — ما لم يكن من كتاب مكتوب ومحفوظ، مما يدل على شدة حرصهم على توثيق الرواية وضبطها بالمقابلة مع النسخة الأصلية.
٣.٤.٢. ضعف الرواة المعتمدين على المخطوطات:أخطر من الاعتماد على الذاكرة هو الاعتماد على المخطوطات. كانت المخطوطات المكتوبة بخط اليد في العصور القديمة، التي تفتقر إلى الحركات وعلامات التشكيل، عرضة للخطأ عند قراءتها. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المخطوطات للتغيير أو التعديل أو الإضافة أو الحذف من قبل الكاتب أو القارئ. لهذا السبب كان العلماء يضعون أهمية كبيرة على قراءة الكتب من قبل المؤلف أو الراوي بنفسه. وكانت الاستماع بالأذن له عدة طرق، إما أن يقرأ الأستاذ النص بينما يقارن الطالب النص المكتوب أمامه، أو يكتب الطالب أثناء قراءة الأستاذ ويقرأه على أستاذه، أو يقرأ طالب آخر النص أمام الأستاذ ويستمع الطالب، أو ينسخ الطالب المخطوط من أستاذه أو من أحد طلابه ثم يقرأه بالكامل أمام الأستاذ. في كل حالة، يجب أن يتم الاستماع إلى النص كما قرأه الكاتب أو الراوي بنفسه حتى لا يقع الطالب في أخطاء عند نقل النص.كان أي راوٍ أو محدث يروي الأحاديث فقط من المخطوطات التي جمعها بدون الاستماع المباشر من أستاذه يُرفض حديثه. من خلال النقد الأدبي والفحص، يمكننا أن نرى العديد من الأمثلة التي أشار فيها المحدثون إلى أخطاء الرواة المعتمدين على المخطوطات وأعلنوا أنهم ضعفاء وغير مقبولين.
وقد ذكرنا سابقاً الإمام عبدالله بن لهيعة، المحدث الفقيه المصري من القرن الثاني الهجري، وهو راوٍ مشهور وروى العديد من الأحاديث. ومع ذلك، فقد اكتشف المحدثون بعد مراجعة رواياته مقارنةً ببعضها البعض أن نسبة الأخطاء في رواياته كانت عالية. وقد أشار الإمام مسلم إلى جانب آخر من أخطائه من خلال دراسة دقيقة.
قال الإمام مسلم: حدثنا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن لَهِيعة قال: أخبرني موسى بن عُكْبَة (١٤١ هـ) أنه كتب لي وقال لي بُسْرُ بن سعيد، عن زَيْد بن ثابت رضي الله عنه قال:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في المسجد."
قال تلميذ ابن لهيعة، إسحاق بن عيسى: قلتُ لابن لهيعة: هل كان في بيته أم في مكان الصلاة؟ فقال: في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم: "هذا الحديث مقلوب في كل جانب، وقع فيه خطأ فادح في السند والمتن. ابن لهيعة قد حرف اللفظ ووقع خطأ في السند. وهذا هو الحديث الصحيح."
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بحْز بن أسَد قال: حدثنا وهب بن خالد بن أَزْلَان (١٦٥ هـ) قال: حدثني موسى بن عُكْبَة قال: سمعتُ أبا نَادِرٍ سَالِم بن أبي أُمَيَّة (١٢٩ هـ) يقول: حدثنا بُسْرُ بن سعيد عن زَيْد بن ثابت قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي...
"اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد غرفة صغيرة من حصير، فصلى فيها عدة ليالٍ..."
قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن المِسْنَى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفَرَازِي (١٤٥ هـ) قال: حدثنا أبو نَادِرٍ سَالِم قال: حدثنا بُسْرُ بن سعيد عن زَيْد بن ثابت قال:
احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصير أو خصفة...
"اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة في المسجد من حصير أو خصفة..."
وبهذه الطريقة، نرى أن وصَفَ الحديث بشكل صحيح من أُوَيْب بن خالد (١٦٥ هـ) عن موسى بن عُكْبَة عن أبي نَادِرٍ. كما ذكرنا في السند الثاني عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفَرَازِي (١٤٥ هـ) والذي روى الحديث عن أبي نَادِرٍ. لكن ابن لهيعة هنا أخطأ في رواية الحديث بخصوص متنه، لأنه لم يسمع الحديث مباشرة من موسى، بل اعتمد فقط على نسخة مكتوبة تم إرسالها إليه، كما ذكر. (لذلك قرأ ابن لهيعة "احتجر" أي "بنى غرفة" بدلاً من "احتجم" أي "أجرى الحجامة"). وبالتالي، نتجنب خطر التحريف في الأحاديث التي يرويها الرواة الذين يعتمدون فقط على النسخ المكتوبة دون سماعها من أئمتهم مباشرة أو قراءة الحديث لهم.
أما في السند، فقد وقع خطأ أيضًا. موسى بن عُكْبَة أخذ الحديث من أبي نَادِرٍ سَالِم، وأبو نَادِرٍ سمعه من بُسْرِ بن سعيد، لكن ابن لهيعة في سنده ذكر أن موسى سمعه مباشرة من بُسْرِ بدون ذكر أبي نَادِرٍ. [مسلم بن الحجاج (٢٦٢ هـ)، التمييز (الرياض، مكتبة الكوثر، الطبعة الثالثة، ١٤١٠ هـ)، ص: ١٨٧-١٨٨].
لذلك، اعتبر العلماء أن الرواة الذين يقتصرون على النسخ المكتوبة دون سماع الحديث مباشرة من المعلمين يعتبرون ضعفاء. حتى لو كان الراوي موثوقًا وصادقًا كما ثبت في كثير من الأحيان، فإن العلماء كانوا يعتبرون روايته ضعيفة إذا كانت تعتمد فقط على النسخة المكتوبة التي لم يسمعها من الإمام أو لم يقرأها له.
أما عن التابعي المشهور في القرن الثاني، عَمْرُو بن شُعَيْب بن مُحَمَّد (١١٨ هـ)، فهو حفيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اتفق العلماء على أنه كان راوٍ موثوق. لكنه عندما رواه عن أبيه عن جده، اعتبر العلماء هذه الأحاديث ضعيفة جزئيًا لأنه لم يسمعها مباشرة من والده، بل قرأها في النسخ المكتوبة. قال يحيى بن معين (٢٣٣ هـ):
إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه.
"عندما يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن ذلك يعتمد على النسخ المكتوبة، ولهذا جاءت ضعفه." [ابن حجر، تهذيب التهذيب ٨/٤٤].
وقال أبو زرعة الرازي (٢٦٤ هـ):
روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وقال إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها.
"رواه عنه الثقات، لكنهم اعترضوا على كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا إنه سمع أحاديث قليلة فقط، وأخذ الصحيفة التي كانت عنده وروى منها." [ابن حجر، المصدر السابق].
أما عن التابعي التابع في القرن الثاني، مَكْرَمَة بن بُكَيْر بن عبد الله (١٥٩ هـ)، فقد اعتبر العلماء حديثه مقبولًا إلى حد ما، ولكنهم ضعفوا الأحاديث التي رواها عن والده. قال يحيى بن معين (٢٣٣ هـ):
وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه ... حديثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه.
"لقد حصل على كتاب أبيه ولم يسمعه منه مباشرة، وروايته عن أبيه تعتمد على النسخ المكتوبة ولم يسمعها منه." [ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٠/٦٣؛ تقريب التهذيب، ص ٥٢٣].
٤. دور المخطوطات في سلسلة الحديثمن خلال النقاش السابق، نفهم أن كتابة الأحاديث وحفظها كان يتم منذ منتصف القرن الثاني الهجري. كان المحدثون يقرؤون الأحاديث من المخطوطات، ويدققون في صحتها، ويختبرونها، وكان كل منهم يسجل الأحاديث التي سمعها. والآن، السؤال هو: لماذا لم يذكروا الكتاب أو المرجع المكتوب عند رواية الحديث، بل اكتفوا بالاعتماد على "الرواية الشفوية" فقط؟ لماذا كانوا يقولون "حدثنا"، "أخبرنا"، ولم يقولوا "في الكتاب الفلاني هذا النص مكتوب"؟في هذا السياق، من المهم أن نفهم المعنى الذي كان المقصود من استخدام "حدثني"، "حدثنا"، "أخبرني"، "أخبرنا"، أي "قال لي"، "أخبرني" في هذا السياق. في الواقع، كان الصحابة يذكرون سلسلة السند من خلال ذكر أسماء الأشخاص، ومن ثم أصبحت هذه الطريقة متبعة في الأجيال التالية في سلسلة الأحاديث. إضافة إلى ذلك، لتعزيز الدقة والتأكد من صحة الرواية وتجنب الأخطاء المتعلقة بالمخطوطات، كان المحدثون يوليون اهتماماً كبيراً لسماع الحديث مباشرة من الشيخ، وليس مجرد الاعتماد على المخطوطات المكتوبة.لذلك، في نقل الأحاديث لم يكن متبعاً إعطاء مراجع المخطوطات، بل كان عادة ما يُذكر اسم الشيخ الراوي.في مصطلحات المحدثين، كان يتم استخدام "حدثني"، "حدثنا"، "أخبرني"، "أخبرنا" بمعنيين: (١) أن الراوي قرأ الحديث مباشرة من على لسان شيخه، وقد سمعه السامع منه، أو (٢) أنه جمع الحديث كتابة ثم قرأه على الشيخ الذي سمعه بدوره. وكان المحدثون يحرصون على أن يكون السماع صحيحاً من الشيخ مباشرة، سواء كان ذلك من الكتابة أو السمع.من خلال هذا، نفهم أنه عندما ذكر مالك في موطأه السند، لم يكن يقصد فقط السماع الشفوي، بل كان الحديث قد سُمع وكتب من المخطوطات، وتم التحقق منه من خلال السمع والمقارنة مع المخطوطات.٥. تقييم طريقة المحدثين في وصف السندمن خلال ما ذكرناه، نرى أن المحدثين قد أدخلوا نظامًا يعتمد على السماع بدلاً من الإشارة إلى المخطوطات والكتب. كانوا يفضلون الاعتماد على السماع من شيوخهم بدلاً من الاعتماد على الكتب المكتوبة، مما جعل هذه الطريقة دقيقة وعلمية للغاية. في العصر الحالي، بدلاً من ذكر أسماء الكتب وأرقام الصفحات كما هو الحال في المراجع الحديثة، كان من الأمان والأكثر منطقية أن يتم ذكر اسم الشيخ باعتباره مرجعًا للحديث. ففي عصر المخطوطات، كانت احتمالية الخطأ في قراءة الكتاب، أو إضافة شخص آخر له، أو الأخطاء في النسخ، أمرًا واردًا. ولكن عندما يتم أخذ الحديث من أفواه العلماء وتعلمه منهم، فإن هذه الأخطاء تصبح معدومة.لنفهم ذلك بشكل أفضل من خلال مثال. أقرب دين للإسلام من حيث الزمن هو المسيحية. فقد نشأت المسيحية في وسط اليهود المتعلمين والمتمدنين في الإمبراطورية الرومانية، ولكن في القرون الأولى، فشل المسيحيون في الحفاظ على كتابهم المقدس وسيرة مؤسس دينهم وتعاليمه. فلم يحاول تلاميذ المسيح أو تلاميذ تلاميذه في القرون الأولى البحث عن صحة الأقوال المنسوبة إلى يسوع أو تحديد مصادرها. بل اعتمدوا على ما تم تداوله شفهياً وكتبه البعض. إذا لم يعجب أحدهم شيئًا، كانوا يرفضونه. لكنهم لم يقوموا بأي فحص نقدي بحثًا عن الحقيقة من خلال تحليل مستقل. ونتيجة لذلك، نجد العديد من الأخطاء والتناقضات في الكتاب المقدس.لم يتمكن العلماء المسيحيون من الحفاظ على سلسلة الإسناد أو التوثيق للمخطوطات القديمة التي تحتوي على هذه الأخطاء والتناقضات. وبالتالي، يحمل العلماء المسيحيون المسؤولية في كثير من الأحيان على "الناسخ"، واصفين أخطاءه بأنها إما "أخطاء" أو "اختلافات في النصوص". كما يقول T. H. Horne: "لقد وضع ميكائيلز تمييزًا دقيقًا بين الخطأ و"القراءات المتنوعة"، حيث يقول: "إذا كان هناك اختلاف بين بيانين أو أكثر، فإنه يُعتبر واحد فقط هو الصحيح، والبقية تكون إما تحريفًا متعمدًا أو خطأ غير مقصود من الناسخ".ففي عملية نسخ الكتاب المقدس، لم يكن هناك أي منهجية تعتمد على السماع المباشر من المعلم أو التحقق من النص الصحيح. في معظم الأحيان، كان ينسخ الخبراء المسيحيون النصوص من المخطوطات الموجودة، مما يؤدي إلى وقوع أخطاء متنوعة.نتيجة لذلك، أظهرت الأبحاث أن الكتاب المقدس يحتوي على العديد من الأخطاء، حيث أثبتت الدراسات مثل دراسة ميل أن الكتاب يحتوي على 30,000 خطأ من "أخطاء الناسخ" أو "القراءات المتنوعة". وأكدت دراسة كريسباخ أن الكتاب المقدس يحتوي على 150,000 خطأ. كما أشار باحث الكتاب المقدس شولتز إلى أن الأخطاء والتناقضات في الكتاب المقدس كثيرة للغاية لدرجة أنه لا يمكن حصرها.ومع ذلك، لا يهدف مقالنا إلى استعراض هذه الأخطاء بالتفصيل. يمكن للقراء المهتمين الاطلاع على العديد من هذه التناقضات والأخطاء في كتب مثل "إظهار الحق" للعلامة رحمة الله كيرانبي، أو في كتاب "هل الكتاب المقدس هو كلمة الله؟" للعلامة أحمد ديدات.هدفنا هنا هو توضيح دقة وحكمة منهج المحدثين في الإسلام. فقد تجنبوا الاعتماد على المخطوطات فقط، واعتبروا السماع المباشر من الشيخ والمقارنة بين المخطوطات وسيلة حاسمة للتوثيق والتحقق من الحديث. وهذا من شأنه أن يضمن تصحيح أي خطأ، سواء كان غير مقصود أو مقصود، من خلال التحقيق والمقارنة. ومن خلال مقارنة الروايات المختلفة، أصبح من السهل تحديد مكان التغيير أو التحريف، مما يحفظ سلاسة ودقة السند.من خلال هذا النقاش، نصل إلى نتيجة مؤكدة، وهي أن الحديث لم يكن يعتمد فقط على السماع، بل كانت المخطوطات تساعد في التأكد من النصوص. ولكن المحدثين لم يعتبروا المخطوطات مرجعية في نقل الحديث، بل كانوا يعطيون أهمية خاصة للسماع المباشر. ومن خلال هذه الطريقة، أثبتوا دقة منهجهم العلمي والمتقن، مما يبرز إعجاز الإسلام.
কপিরাইট স্বত্ব © ২০২৫ আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট - সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত| Design & Developed By Biz IT BD
