সাম্প্রতিক আপডেট
الرد على بعض البدع عند الصوفية من قبل مجدد الألف الثاني
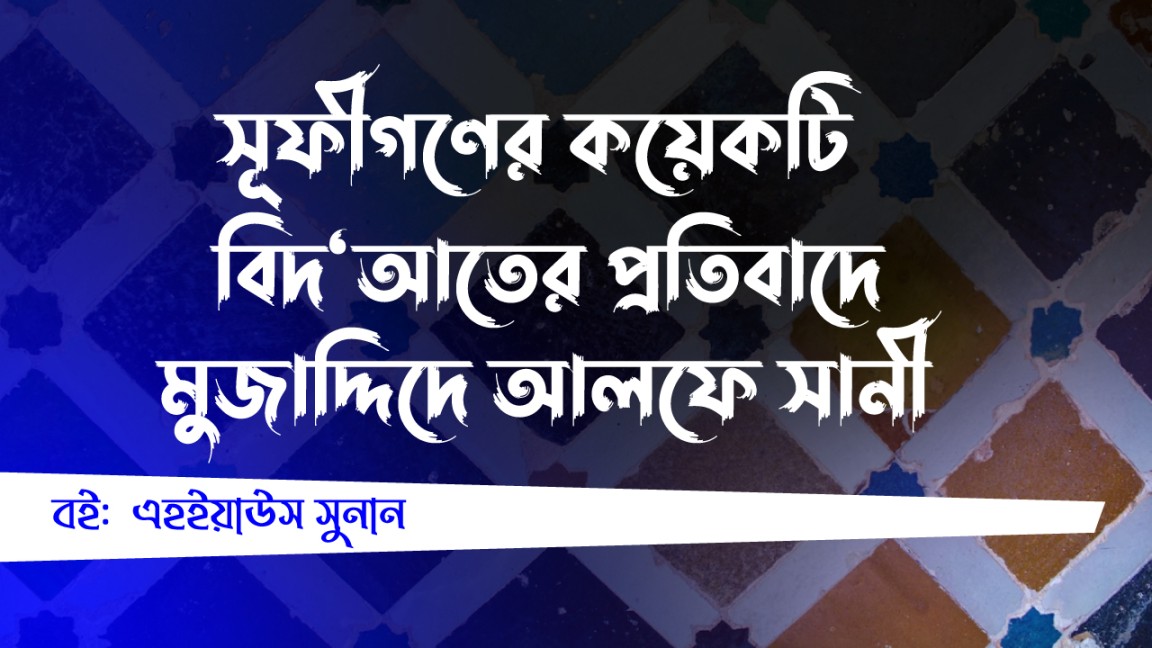
(١٣) الرد على بعض البدع عند الصوفية من قبل مجدد الألف الثاني
(أ) صوفية العصر الأول مقابل صوفية العصور المتأخرة
سبق أن ذكرنا أن صوفية العصر الأول كانوا كاملي الاتباع للسنة النبوية. كانوا من ناحية متعمقين في علوم القرآن والسنة والفقه، ومن ناحية أخرى كانوا روادًا في السير الروحي والكمالات الإيمانية باتباعهم وتقليدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان صوفية القرنين الثاني والثالث الهجريين يعتمدون أساسًا على القرآن والسنة ومنهج الصحابة في الإكثار من النوافل وترك الشهوات ومخالفة الهوى والاعتزال وغير ذلك من وسائل الترقي الروحي. كانوا جميعًا يركزون على تعميق الفهم للقرآن والسنة وتنظيم الحياة وفقًا للمعارف المكتسبة. وقد سبق أن ذكرنا بعض أقوال أبرز صوفية القرن الثالث في هذا الصدد.
لكن في العصور المتأخرة، بسبب الاضطرابات العامة في العالم الإسلامي، وضعف الاهتمام بعلوم الفقه والحديث وغيرها من المعارف الإسلامية، والتأثيرات الأجنبية، انتشرت بين الصوفية أساليب جديدة اعتُبرت بدعة حسنة أو جائزة. وقد ذكر مجدد الألف الثاني خصوصًا بعض هذه البدع الحسنة المعروفة.
البدعة الأولى: الذِّكر الجَهري (الذِّكر بصوت مرتفع)
الذِّكر من العبادات المهمة في الإسلام. لقد علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الذِّكر، ومتى يُقال، وبأي صيغة. هو وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يلتزمون بذلك. لم يكونوا يجتمعون للذكر بصوت مرتفع جماعيًا قط، إلا أنه في بعض الأحيان كان يُسمع منهم بعض الأذكار بصوت عالٍ بشكل فردي.
مثلاً، بعد صلاة الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" ثلاث مرات، وكان يمد بها صوته في المرة الأخيرة. وأحيانًا بعد التسليم من الصلاة، كان يقول التكبير والتهليل بصوت مسموع مرة أو مرتين. بخلاف هذه الحالات النادرة، كان الذِّكر الدائم يُؤدَّى سرًّا في القلب.
واستنادًا إلى هذه الحالات النادرة من الذِّكر الجَهري، قيل بجواز الذِّكر بصوت مرتفع. ثم بدأ الصوفية يُركِّزون على الذِّكر الجَهري، حتى أصبح معظم أذكارهم تُؤدَّى بصوت عالٍ أو بشكل جماعي، وهو ما تحوَّل إلى عادة راسخة عندهم.
البدعة الثانية: الذِّكر بالوقوف أو القفز والحركة
منذ عدة قرون، انتشر بين الصوفية عادة الذِّكر جماعيًا مع الوقوف أو التمايل أو القفز. وقد أيَّد بعض العلماء هذه الممارسات بحجة أن هذه الطريقة في الذِّكر وإن لم تكن موجودة في عهد الصحابة، إلا أن الذِّكر جائز في كل حال، سواء كان قائمًا أو قاعدًا. وزعموا أن هذه الطريقة الجديدة في الذِّكر تُورث المحبة الإلهية وتطهِّر القلب، فلا حرج فيها. ورأوا أنها وإن لم تكن سنة، فهي بدعة حسنة ومستحبة.
البدعة الثالثة: الخلوة والعزلة (اعتزال الناس للعبادة)
للعزلة فوائد عظيمة في تطهير القلب وتحريره من التعلقات الدنيوية. لهذا السبب، اعتاد رجال الدين والزهاد منذ القدم على الانعزال والتفرغ للعبادة، حيث كانوا يبتعدون عن ضجيج الدنيا ويتفرغون لعبادة خالقهم وتأمله بإخلاص. ومن خلال ذلك، حققوا قوة روحية وتقدمًا في سيرهم إلى الله.
لكن الإسلام لم يؤيد أبدًا هذا النوع من العزلة أو الرهبانية. بل أمر المسلم بالمشاركة الفعالة في المجتمع، والعمل على إصلاحه، مع الحفاظ على صلاح نفسه. ومع ذلك، إذا كان المجتمع غارقًا في المعاصي، فمن المستحب للمرء أن يعتزل بعض الشيء في حياته الشخصية مع بقائه داخل المجتمع.
بناءً على بعض الأحاديث التي تتحدث عن الانعزال المؤقت، اختار العديد من الصوفية العزلة الكاملة أو العيش في الغابات والجبال، معتقدين أن ذلك طريقٌ للوصول إلى أعلى درجات المحبة الإلهية ونيل الولاية والكرامات. وفي كتب وسير معظم المتصوفة في العصور الوسطى، نجد العديد من القصص المشابهة.
وفي الطريقة القادرية وغيرها من الطرق الصوفية، أصبحت "الخلوة" (مثل العزلة لمدة أربعين يومًا أو عدة فترات من الأربعين) جزءًا أساسيًا من التربية الروحية، حيث يعتاد المريد على هذه الممارسة كوسيلة للتقرب إلى الله.
البدعة الرابعة: السماع والغناء (الموسيقى والطقوس الصوفية)
في العصور الأولى للإسلام، كان مصطلح "السماع" يُقصد به فقط الاستماع إلى القرآن الكريم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. هذه الأمور وحدها كانت تثير في قلوبهم حب الله وحب الرسول. لم يكن المسلمون يستمعون إلى الأغاني كوسيلة للتقرب إلى الله أو لتنمية المحبة الإلهية في قلوبهم.
كانت الموسيقى والغناء موجودة بشكل محدود بين أهل اللهو والفساق كوسيلة للتسلية، لكن العلماء عموماً اعتبروها محرمة. حاول بعض الأفراد القليلون الترخيص بها كوسيلة ترفيه، لكنها لم تُعتبر أبداً وسيلة مشروعة للتقرب إلى الله.
مع مرور الوقت، أصبح الغناء والموسيقى جزءاً من الممارسات الدينية للصوفية والمتقين، وأطلقوا عليها اسم "السماع". ومنذ القرن الخامس الهجري، أصبح "السماع" عنصراً أساسياً في الطقوس الصوفية. لم يعد من الممكن تصور تكية صوفية أو مجلس صوفي بدون "السماع".
كان الصوفية يغنون ويستمعون إلى الأغاني العادية التي تتحدث عن العشق والفراق واللقاء، معتبرين أنها تثير في قلوبهم الشوق إلى الله وألم الفراق عنه. وكانوا يرقصون على أنغام هذه الأغاني، وفي حالات النشوة الروحية كان البعض يمزق ملابسه. أقيمت مجالس "السماع" بانتظام، بعضها بمصاحبة الآلات الموسيقية وبعضها بدونها، لأنهم اعتقدوا أن هذه الأغاني والموشحات تثير في قلوب العاشقين حب الله. بل اعتبروا "السماع" وسيلة من وسائل الوصول إلى الله ونيل محبته.
السماع والغناء والإمام الغزالي
عندما ينتشر أي عمل في المجتمع بشكل واسع، خاصة بين الصالحين والمتقين، يسعى بعض العلماء إلى تقديم مبررات لهذه الممارسات ويحاولون إثبات جوازها أو موافقتها للإسلام. وقد حدث هذا مع الغناء والموسيقى أيضًا.
بعض العلماء، احترامًا للصوفية ولما يجدونه في قلوبهم من انجذاب عاطفي وفرح عند سماع الغناء، أفتوا بجوازه. ومن أبرز هؤلاء الإمام الغزالي (ت. 505 هـ)، الذي حاول في كتابه الشهير "إحياء علوم الدين" أن يثبت جواز الغناء والموسيقى والرقص عبر مناقشة مطولة.
اعترف الغزالي بأن هذه الممارسات لم تكن معروفة في عهد النبي ﷺ ولا في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. ومع ذلك، ادَّعى أن الغناء، والعزف، وحفلات الموسيقى، والرقص في مجالس السماع، وحتى خلع العمائم وتمزيق الملابس هي من "البدع الحسنة" الجائزة. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فاعتبر هذه الأمور من زاد السالكين في طريق الله! (٣٩)
(٣٩) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢/٢٩٢-٣٣٢.
السماع والغناء والشيخ عبد القادر الجيلاني
من ناحية أخرى، لم يستطع بعض العلماء تقبل انتشار هذه الممارسات في المجتمع. فقد اعتبروا عصر النبي ﷺ وعصر الصحابة والتابعين وتابعيهم هو المعيار الأساسي. وبما أن الغناء والرقص وما شابه ذلك لم تكن أبدًا من ممارسات السالكين في طريق الله في تلك العصور، بل كانت من أفعال الفاسقين والمبتعدين عن الدين، فقد رفضوا هذه الممارسات رغم انتشارها بين الصوفية، وحاولوا منعها. لكنهم شعروا أن كلمتهم لم تلقَ آذانًا صاغية من عامة الصوفية، وأنهم عاجزون عن إيقاف موجة الغناء والرقص.
نلمس هذا الشعور في كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت. 561 هـ)، الذي كان أحد أبرز العلماء والزهاد في القرن السادس الهجري. رغم معارضته الشخصية للسماع المصحوب بالموسيقى والرقص، إلا أنه اعترف بانتشار هذه الممارسات بين الصوفية في عصره، وقبل بها مضطرًا بسبب ظروف الزمن.
(٤٠) عبد القادر الجيلاني، غنية الطالبين (ترجمة: إ.ن.م. عماد الله)، ٢/٣٥٩.
السماع والموسيقى في عصر مجدد الألف الثاني: جزء لا يتجزأ من التصوف
بهذه الطريقة، أصبح "السماع" – سواء مع الآلات الموسيقية أو بدونها – مصحوبًا بالرقص في حالات الوجد وتمزيق الملابس، جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الصوفية.
من يقرأ السير الذاتية للصوفية في العصور الوسطى، أو كتابات المؤرخين المعاصرين أو اللاحقين عن حياتهم، سيدرك مدى انتشار وعمومية هذه الممارسات في عصر مجدد الألف الثاني (الإمام أحمد السرهندي).
لفهم مدى شيوع "السماع" والغناء والرقص في حالات النشوة بين صوفية الهند – وخاصة في الطريقة الجشتية – أدعو القارئ لاستعراض الكتب التالية:
"أنيس الأرواح" لخواجة معين الدين الجشتي
"دليل العارفين" لخواجة قطب الدين بختيار كاكي
"فوائد السالكين" لخواجة فريد الدين گنج شكر
"راحة القلوب" و "راحة المحبين" لخواجة نظام الدين أولياء
"أخبار الأخيار" لعبد الحق محدث دهلوي
(ب) معارضة مجدد الألف الثاني لهذه البدع
في مثل هذه البيئة، وقف الإمام السرهندي (مجدّد الألف الثاني) بشدة ضد هذه "البدع الحسنة"، ونصح بالعودة إلى منهج الصوفية الأوائل، ووصف جميع الأساليب الأخرى بالباطلة.
وأكّد مرارًا أن مشايخ الطريقة النقشبندية الأصليين قد تخلّوا عن كل بدعة واتبعوا السنة فقط، وبذلك نالوا المقامات العالية. كان اتباع السنة هو أملهم الوحيد في الحياة، حتى لو لم يحصلوا على أي لذّة روحية أو معرفة (معرفة الله) أو أنوار أخرى في طريقهم.
وكتب في أحد رسائله:"لأن هؤلاء المشايخ العظام تمسكوا بشدة باتباع السنة واجتنبوا البدع كليًا، فإنهم لو حصلوا على سعادة الاتباع دون أن يشعروا بأي حال روحي، لظلوا راضين. لكنهم حتى لو نالوا جميع الأحوال الروحية، فإنهم لا يقبلون أبدًا أي انحراف عن السنة." (٤١)(٤١) المکتوبات الشريفة، مکتوب ۲۱۰، ص ۱۱٥.
وقد تأسف الإمام السرهندي كثيرًا على انتشار البدع بين أتباع الطريقة النقشبندية في عصره، حيث قال:
"فاعلم أن رفعة هذه الطريقة النقشبندية إنما كانت بسبب اتباع السنة والابتعاد الكامل عن البدعة. ولهذا السبب، نهى كبار هذه الطريقة عن الذكر الجهري، وأمروا بالذكر القلبي، أي الذكر بالقلب. وقد منعوا الرقص والغناء والقفز، وهي أمور لم تكن موجودة في زمن النبي الكريم ﷺ ولا في زمن الخلفاء الراشدين. وبدلاً من العزلة والانقطاع التي لم تكن في زمن الصحابة، اتخذوا العزلة بين الناس. فبسبب اتباعهم للسنة، حصلوا على فوائد عظيمة...
أما في هذا الزمان، فقد أصبحت تلك النسبة كأنها زهرة في الهواء أو شبه مفقودة... فإن أتباع الطريقة النقشبندية اليوم قد أصبحوا مضطربين، فتركوا طريق أسلافهم الكرام، ويحاولون أن يجدوا السكينة في الذكر الجهري، وأحيانًا في الرقص والغناء. ولأنهم لم يستطيعوا العزلة بين الناس، بدأوا في الاعتكاف والانقطاع. والعجيب أنهم يعتبرون هذه الأعمال البدعية كأنها كمال في النسبة لهذه الطريقة، ويظنون أن الخراب هو البناء...
يا أخي المخدوم، لقد انتشرت البدع في هذه الطريقة إلى درجة أنه لو قال الخصم إن هذه الطريقة هي لنشر البدع وترك السنة، لكان له وجه في ذلك..."
📘 (المكتوبات، رقم ١٦٨، ص ٣٥–٣٦)
إحياء السنن: التمسك بالسنة واجتناب البدعة
المؤلف: د. خوندكر عبد الله جهانجير راه.
কপিরাইট স্বত্ব © ২০২৫ আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট - সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত| Design & Developed By Biz IT BD
