সাম্প্রতিক আপডেট
الموت، والجنازة، والدعاء
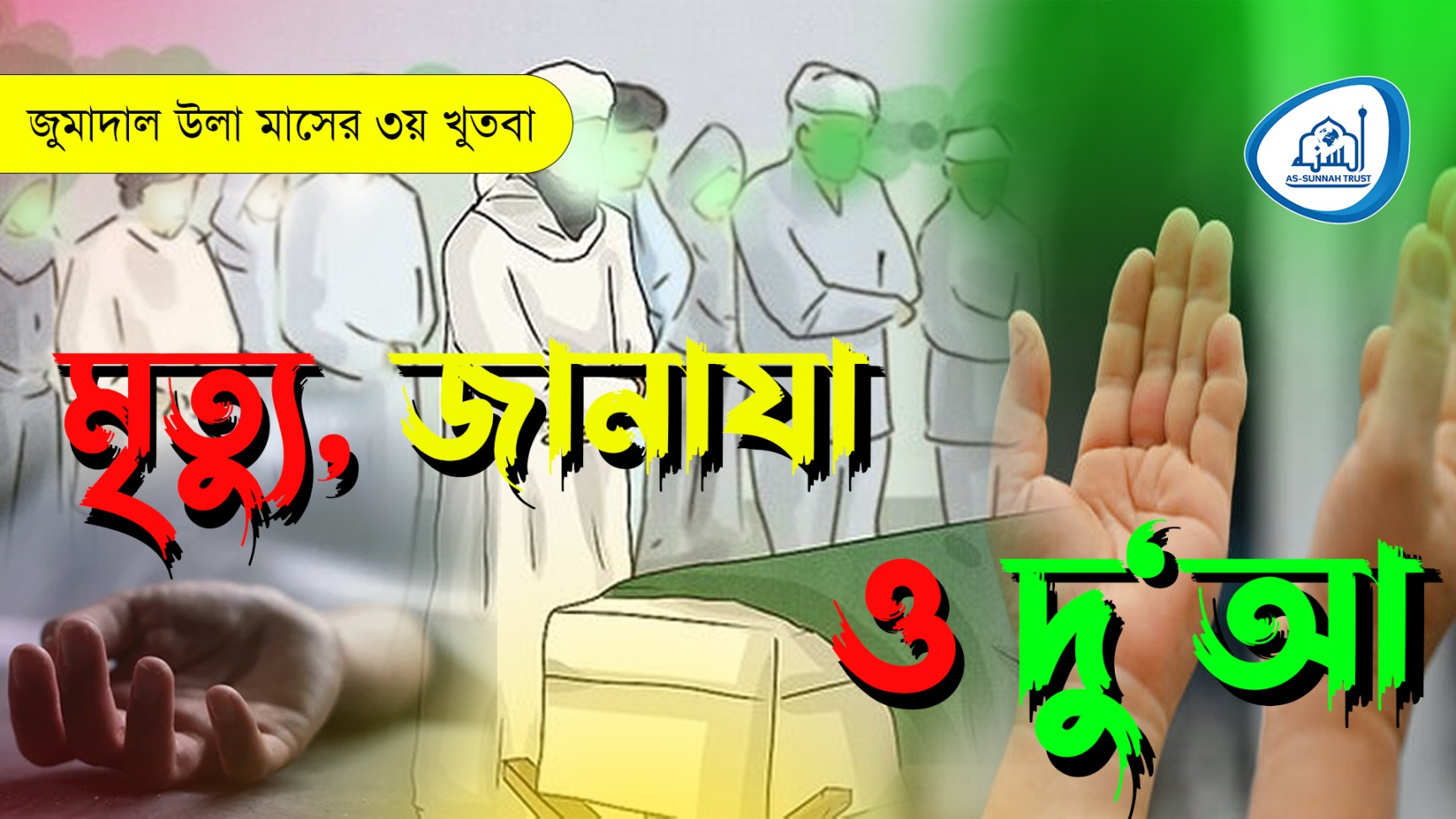
خطبة جمعة من شهر جمادى الأولى: الموت، والجنازة، والدعاء
الحمد
لله، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد،
فاليوم
هو الجمعة الثالثة من شهر جمادى الأولى. سنتحدث اليوم -بإذن الله- عن الموت
والجنازة والموضوعات ذات الصلة. ولكن قبل ذلك، نسلط الضوء بإيجاز على الأسابيع
والأيام الوطنية والدولية لهذا الأسبوع.
اليوم
هو اليوم ... من شهر ... الميلادي. ومن بين أيام هذا الأسبوع:
............................................... .
الموت
هو المصير المحتوم لكل حياة. نحن لا نريد الموت لأنفسنا، بل لا نريد حتى التفكير
في الموت. نحن نحزن على وفاة أحبائنا. ولكن رغم كل الاعتراضات والأحزان والكراهية،
يظل الموت هو أكبر حقيقة في الحياة. والحقيقة الأكبر هي أننا لا نعرف أي منا متى
سيموت. والأهم من ذلك كله أن الحياة التي نتوق إليها بشدة ليست شيئًا مقارنة
بالحياة بعد الموت. لذلك، يجب أن نتقبل حقيقة الحياة ونستعد للموت. إن الاستعداد
لاستقبال قادم لا يمكن ردّه بأي حال من الأحوال هو عمل الحكماء. وأفضل طريقة
لاستقباله هي تذكر موعد قدومه مرارًا وتكرارًا. لقد أرسلنا الله إلى الدنيا، ويجب
أن نحاول أن نحيا بشكل جيد طالما أبقانا الله أحياء، وأن نسعى لتحقيق النجاح
الدنيوي. ولكن ليس على حساب إفساد الآخرة. بما أن المغادرة حتمية، فلماذا الخصام
بلا سبب؟ لنغادر في سلام ومحبة قدر الإمكان. على الأقل ستقل الذنوب. على الأقل
سيدعو للناس مرة واحدة بعد موتهم.
يجب
الصبر على المرض. لأن كل مرض ومعاناة تجلب الأجر للمؤمن. لا بأس في التعبير عن
الألم أو المعاناة بشكل طبيعي بالكلام. ولكن يجب تجنب إلقاء اللوم على الله أو
القدر بسبب المرض، أو قول كلمات غير لائقة. فهذا لا يزيل البلاء أبدًا، بل يكتسب
الذنب فقط. لا يجوز التمني للموت في أي شدة. الحياة هي أعظم نعمة من الله. لا يجوز
تمني الموت حتى في أشد الشدائد، فكيف بإتلافها أو الانتحار. هذه الأمنية لا تعجل
الموت، ولا تقلل المعاناة، ولكنها تدمر أجر المؤمن وتكسبه الإثم. مرض العباس رضي
الله عنه فتمنى الموت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتمنوا
الموت، يا عم. فإن كنت محسناً تزداد إحساناً إلى إحسانك، وإن كنت مسيئاً فتمهلك
الله حتى تتوب من إساءتك. فلا تتمنوا الموت." [الحاكم، المستدرك 1/489]. وفي
حديث آخر قال: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلاً
فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً
لي."[البخاري 5/2146، 2337؛ مسلم 4/2064].
ينبغي
لكل مؤمن أن يكون مستعداً للموت. أن يؤدي ما عليه من حقوق أو يترك ترتيبات لأدائها
ويوصي بذلك. وهناك وصية خاصة ينبغي لكل مؤمن أن يوصي بها، وهي أن يدفن وفق الطريقة
السنية الكاملة. ففي أواخر القرن الأول الهجري، عندما بدأت تظهر بعض الاستثناءات
في
matters like الجنازة والقبور بسبب تأثير دخلاء المسلمين
الجدد وتأثير تقاليد الأديان السابقة أو المجاورة، كان الصحابة والتابعون يوصون
بمثل هذه الوصية.
إن
نجاح الإنسان في الآخرة يعتمد على عمله. لذلك، لا يمكن الحكم عليه بالخير أو الشر
بمجرد النظر إلى حالته عند الموت. ومع ذلك، يمكن وصف بعض أنواع الموت بأنها موتة
حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه 'لا إله إلا
الله' دخل الجنة" في وقت ما، ولو بعد أن يعذب. [أبو داود، السنن ٣/١٩٠؛ ابن
حبان، الصحيح ٧/٢٧٢؛ الألباني، أحكام الجنائز، ص ١٠. الحديث صحيح]. وفي حديث آخر
قال: "موت المؤمن بعرق الجبين". [الترمذي، السنن ٣/٣١٠؛ النسائي، السنن
٤/٥-٦؛ ابن ماجه ١/٤٦٧؛ أحمد، المسند ٥/٣٥٠، ٣٥٧، ٣٦٠. الحديث حسن]. وفي حديث آخر
قال: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة
القبر". [الترمذي، السنن ٣/٣٨٦؛ أحمد، المسند ٢/١٦٩؛ الألباني، أحكام
الجنائز، ص ٣٥. الحديث صحيح]. أي أن حسابه وجزاؤه أو عقابه سيكون يوم
القيامة، ولكن سيكون محمياً من عذاب القبر حتى القيامة.
نحن
جميعاً نعرف فضل الموت شهيداً (الشهادة). في أحاديث صحيحة مختلفة، تم وصف أنواع
الموت التالية بأنها شهادة: (١) الموت بالطاعون أو الوباء، (٢) الموت بمرض البطن،
(٣) الموت غرقاً، أو تحت الأنقاض، أو انهيار المنزل، (٤) الموت بسبب مرض النفاس،
(٥) الموت حرقاً، (٦) الموت بذات الجنب (الجنب) أو مرض الصدر، (٧) الموت بمرض
السل، (٨) الموت أثناء الدفاع عن النفس، أو العائلة، أو الشرف، أو المال. في ضوء
هذه الأحاديث، يمكننا أن نفهم أن الموت بسبب جميع الأمراض المستعصية، والموت غير
الطبيعي أو المؤلم، والموت دفاعاً عن الحقوق، والقتل مظلوماً يعتبر شهادة. [للتفاصيل
انظر: محمد ناصر الدين الألباني، أحكام الجنائز، ص ٣٤-٤٣].
عند
زيارة الشخص المريض الذي يحتضر أو المتوفى، يجب الدعاء له ولأسرته بالخير. فقد ورد
في الحديث الصحيح أن الملائكة تؤمن على الدعاء في هذا الوقت. [مسلم، الصحيح
٢/٦٣٣-٦٣٤].
يجب
تلقين الشخص المحتضر كلمة الشهادة (الكلمة الطيبة)، أي حثه على نطق الشهادة. بعد
وفاة الشخص، فإن الواجب السني على الحاضرين هو إغماض عينيه، والدعاء له ولأسرته،
وتغطية جسده كاملاً بثوب كبير، وترتيب دفنه بسرعة.
من
أحاديث مختلفة نعلم أنه يجب ترتيب سداد ديون المتوفى بسرعة، حتى قبل دفنه. لهذا
الغرض، يجب إنفاق جميع أمواله إذا لزم الأمر. لأن الميراث لا يتم توزيعه قبل سداد
الديون. إذا لم يكن لديه ما يكفي من المال لسداد الديون، فإن مسؤولية الدولة هي
سدادها. إذا لم يكن هناك نظام حكومي كهذا، فيجوز لأي شخص أن يتبرع بسداد الدين
نيابة عنه. ورد في الأحاديث النبوية repeatedly أن روح المتوفى تكون معلقة
حتى يتم سداد دينه، وإذا لم يتم سداد الدين، فإنه يدخل النار.
الموت
يجلب دائماً الحزن للأحياء. ولكن يجب السيطرة على التعبير عن الحزن. تعليم رسول
الله صلى الله عليه وسلم هو أن أقارب المتوفى يمكنهم إظهار الحزن الطبيعي لمدة
ثلاثة أيام. خلال هذا الوقت، قد يكون هناك بكاء صامت طبيعي، وإظهار الألم، وعدم
الترتيب في الملابس. بعد ثلاثة أيام، لا يجوز إظهار الحزن أو البكاء علناً. أما
الصراخ والبكاء، والندب، ولطم الخدود أو الصدور، ونتف الشعر أو حلق الرأس، فهي
محرمة في جميع الأحوال.
خلال
فترة حزن أهل المتوفى، فإن واجب المسلمين الآخرين هو تعزيتهم والدعاء لهم. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عزى أخاه المؤمن في مصيبة، كساه الله من
حلل الكرامة يوم القيامة". [للتفاصيل انظر: محمد ناصر الدين الألباني، أحكام
الجنائز، ص ١٦٣].
من
أحاديث مختلفة يمكننا أن نعرف أنه بعد وفاة الشخص، إذا أشاد جيرانه المقربون
والأشخاص المطلعون عليه تلقائياً بتقواه أو ذموا فجوره، فإن ذلك يقبل عند الله.
ورد في الحديث الشريف: بعد وفاة رجل، استمر الناس في الثناء على تقواه. فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "وجبت" (أصبحت واجبة). وبعد وفاة رجل آخر، ذمه
مختلف الناس على تقواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وجبت".
وعندما سأله الصحابة عن معنى هذا القول، قال: "المؤمنون شهداء الله في الأرض،
فمن شهدوا له بخير وجبت له الجنة، ومن شهدوا عليه بشر وجبت له النار". [البخاري،
الصحيح ١/٤٦٠، ٢/٩٣٤؛ مسلم، الصحيح ٢/٦٥٥؛ الألباني، أحكام الجنائز، ص ٤٤]. وفي
حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ
فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ قَبِلْتُ
عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ". [الحاكم، المستدرك ١/٥٣٤؛
أحمد، المسند ٢/٤٠٨، ٣/٢٤٢؛ الألباني، أحكام الجنائز، ص ٤٥. الحديث صحيح].
في
بلدنا، كثيراً ما يُسأل الحاضرون أمام الجثة، قبل صلاة الجنازة: "كيف كان هذا
الشخص؟" فيرد الحاضرون: "كان شخصاً طيباً". هذه العملية مخالفة
للسنة وهي مجرد خداع للنفس. لم يسبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه أن
سألوا المصلين بهذه الطريقة. الحديث قدّر قيمة الثناء العفوي. بالإضافة إلى ذلك،
يتضح من أحاديث مختلفة أن الثناء أو الذم يجب أن يكون متعلقاً بالتقوى والدين.
والأهم من ذلك، أن الأحاديث الشريفة وصفت الأمر repeatedly بأنه
شهادة (شهادة). والمؤمن لا يمكن أن يشهد بشهادة زور عند الله. هل يمكن للمؤمن الذي
يعلم في قلبه أن الشخص كان فاسقاً أن يشهد بأنه صالح؟ وهل يمكن خداع الله بمثل هذه
الشهادة؟ لذلك، الموضوع الأساسي هو أن يعيش المؤمن حياةً لا يعرف عنه أقرباؤه إلا
الخير، وبسبب تقواه وأخلاقه الحسنة، سيخرج الثناء العفوي على تدينه من أفواههم.
وبسبب مثل هذه الشهادة، يغفر الله ذنوبه الخفية ويدخله الجنة.
بيّن
رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث أهمية ومكانة المشاركة في
صلاة الجنازة واتباع الجنازة. سابقاً عرفنا فضل المشاركة في صلاة الجنازة يوم
الجمعة أو أثناء الصيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً: "مَنْ
شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى
تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ
الْعَظِيمَيْنِ". (أي: "من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى
تدفن فله قيراطان. والقيراطان مثل الجبلين العظيمين").[البخاري، الصحيح
١/٤٤٥؛ مسلم، الصحيح ٢/٦٥٢-٦٥٣].
السنّة
أثناء حمل الجنازة واتباعها هي الحفاظ على الصمت التام. رفع الصوت بقراءة الكلمات
(كالتهليل)، أو الذكر، أو التحدث، أو تشغيل أشرطة الكاسيت، وما شابه ذلك، كلها بدع
مخالفة للسنة وأعمال مكروهة. قال الإمام العلامة الكاساني الحنفي في كتابه
"بدائع الصنائع": "يُسَنُّ الإِسْرَاتُ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ
أَيْ: السُّكُوتُ. وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ
عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
كَانُوا يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ أَمَاكِنَ: عِنْدَ
الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ، وَعِنْدَ الذِّكْرِ. وَلِأَنَّ فِيهِ
مُشَابَهَةً لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَيَكْرَهُ". [الكاساني، بدائع
الصنائع ١/٣١٠].
عادة
تجصيص القبور (تبييضها أو تبليطها) قديمة جداً. منذ العصور القديمة، كان الناس
يقوون القبور للحفاظ على ذكرى موتاهم، بل كانوا
يبنون الأهرامات. كانت هذه الممارسة سائدة أيضاً في البلاد العربية. في أحاديث
مختلفة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بشدة. في حديث، قال جابر رضي
الله عنه: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ
الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ". (أي:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصص القبر (يُطلى بالجص)، وأن يقعد
عليه، وأن يبنى عليه"). [صحيح مسلم، كتاب الجنائز، رقم ١٦١٠]. وردت أحاديث
أخرى بهذا المعنى، يُفهم منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أمور:
تجصيص القبور، والجلوس على القبور، وبناء القبور أو تشييد anything like a
building عليها، والكتابة على القبور، ورفع القبر بشكل
مبالغ فيه بإضافة تراب من مكان آخر.[أبو داود، رقم ٣٢٣٥، ٣٢٢٦؛ الترمذي،
١٠٥٢؛ ابن الأثير، جامع الأصول ١١/١٤٥-١٤٦].
ليس
فقط تجصيص القبور محظوراً، بلأمر بهدم القبور المبنية.[صحيح مسلم، كتاب
الجنائز، رقم ٩٦٩]. في مقابل هذه الأحاديث، لم يأت أي حديث واحد يجيز تجصيص
القبور. لم يفعل هو أو أصحابه ذلك أبداً. الأئمة الأربعة اعتبروا هذا مكروهاً أو
حراماً. قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أحد أئمة المذهب الحنفي:
"مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُرَفَّعُ الْقَبْرُ بِالتُّرَابِ إِلَّا بِمَا
خَرَجَ مِنْهُ. يُرَفَّعُ بِتُرَابِ الْقَبْرِ نَفْسِهِ مَقْدَارَ مَا يُعْرَفُ
أَنَّهُ قَبْرٌ لِئَلَّا يُدَاسَ. وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ أَوْ طِينِهِ
بِالْمَاءِ. وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ بِنَاءُ مَسْجِدٍ عِنْدَ الْقَبْرِ أَوْ نَصْبُ عَلَمٍ
أَوْ شِعَارٍ أَوْ رَابِيَةٍ أَوْ نَصْبُ شَيْءٍ لِلتَّذْكِرَةِ. وَالْكِتَابَةُ
عَلَى الْقَبْرِ أَيْضاً مَكْرُوهَةٌ. وَبِنَاءُ بَيْتٍ عَلَى الْقَبْرِ
بِاللَّبِنِ أَوْ تَقْوِيَةُ جَوْفِ الْقَبْرِ بِاللَّبِنِ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ.
أَمَّا رَشُّ الْمَاءِ (عَلَى الْقَبْرِ) فَلَا نَرَى بِهِ بَأْساً. هَذَا قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ".[محمد بن حسن الشيباني، كتاب الآثار
٢/١٨٢-١٩٠].
المكروه
(في هذا السياق) يعني المكروه تحريماً، وهو في مرتبة الحرام، ويُؤثم فاعله. أيها
الحاضرون، هل من المعقول إنفاق المال لكسب الإثم؟ إذا تبرعتم بالأموال بدلاً من
تجصيص القبور، لكان الميت ينال الأجر. أما إذا قمتم بتجصيص القبر، فستكسبون الإثم
وهم لن ينالوا شيئاً.
زيارة
القبور هي من الأعمال الصالحة المشروعة بالسنة. في ضوء السنة، هناك هدفان لزيارة
القبور: (١) تذكير الآخرة، و(٢) تسليم السلام على الموتى والدعاء لهم. عند
الزيارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل القبور ويدعو لهم دعاءً
موجزاً جداً: "السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ
الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ
بِكُمْ لَاحِقُونَ" (أي:
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين،
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). [صحيح مسلم، كتاب الجنائز، رقم ٩٧٤]. في جميع
الأحاديث الأخرى حول زيارة القبور، ذُكر هذا الدعاء، مع اختلاف طفيف في بعض
الكلمات.
بعد
وفاة الأحباء، تبقى رغبة في فعل شيء لهم أو تقديم شيء لهم. في هذا الصدد،
المسؤولية الأساسية للأبناء هي الالتزام بالإسلام بأنفسهم والعمل الصالح بكثرة.
لأن أي عمل صالح يفعله الأبناء، فإن الوالدين سيحصلان على أجر كامل منه، دون أن
ينقص من أجر الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ
كَسْبِهِ" (أي: إن أطيب ما
أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه). [الترمذي، السنن ٣/٦٣٩؛ أبو داود، السنن
٣/٢٨٩؛ النسائي، السنن ٧/٢٤١؛ ابن ماجه ٢/٧٦٨-٧٦٩. الحديث صحيح]. لذلك،
يعتبر عمل الابن الصالح أيضاً من كسب الوالدين. ويمكن فهم هذا من أحاديث مختلفة.
بالإضافة
إلى الأعمال الصالحة الخاصة بهم، توجد توجيهات من الأحاديث للقيام ببعض الأعمال
الأخرى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا رسول الله، هل
بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟" فقال: "نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا (أي: الدعاء لهما)، وَالِاسْتِغْفَارُ
لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي
لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا" (أي:
نعم، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا
توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما). [أبو داود، السنن ٤/٣٣٦؛ ابن ماجه ٢/١٢٠٨؛
الحاكم، المستدرك ٤/١٧١. صححه الحاكم والذهبي].
قال
الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمي
ماتت وأنا غائب عنها، فأي الصدقة أفضل؟" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء". فحفر بئراً وقال: هذه لأم سعد.
[البخاري، الصحيح ١/٤٦٧، ٣/١٠١٥؛ مسلم، الصحيح ٣/١٢٥٤؛ أبو داود ٢/١٣٠،
٣/١١٦؛ الألباني، أحكام الجنائز، ص ١٧٢].]
بهذه
الطريقة، وردت في أحاديث مختلفة توجيهات بالدعاء والصدقة عن الميت. لم يرد في أي
حديث صحيح توجيه بختْم القرآن (ختمة) أو ختم التهليلات (الذكر) وما شابه ذلك. قال
بعض العلماء: بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء والصدقة، فالتعدي
عن ذلك لا فائدة منه. وقال many scholars: بما أن الله سيعطي الميت
أجر الدعاء والصدقة، فما المانع من أن يعطيه أجر ختم القرآن أو الذكر أيضًا؟ إذا
ختم الأقارب القرآن بنية إهداء الثواب للميت، فقد يوصّل الله ذلك الثواب إليه. أما
الذين لا يستطيعون قراءة القرآن فيتصدقون ويدعون. أما إقامة gatherings (حفلات) من أجل الختم فهي أفعال مخالفة للسنة تماماً.
الترتيبات formelles (الحفلات) وتحديد أوقات محددة للدعاء أو الصدقة هي أيضاً أفعال
مخالفة للسنة. الدعاء لا يعني أبداً إقامة gatherings للدعاء، ولا يعني تحديد أوقات للدعاء مثل ٣ أيام، ٧ أيام، ٤٠
يوماً، يوم الميلاد، يوم الوفاة، إلخ. معنى الدعاء هو أن يدعو الابن أو القريب في
كل وقت، عند تذكرهم، أثناء الصلاة، أو عند الدعاء لأنفسهم، أو بشكل عام في أي وقت،
أثناء المشي، أو الجلوس، أو الاستلقاء، يطلبون من الله المغفرة والرحمة للوالدين
والأموات الآخرين. من أحاديث مختلفة نعلم أنه إذا قُبل such دعاء، فإن الله يكتب الأجر في سجل أعمال الميت.
"اللهم اغفر لأمي وارحمها" (اللهم اغفر لأمي
وارحمها) "رَبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا" (ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً),
نحن sometimes نعتقد أننا مذنبون، لذا لن يُقبل دعاؤنا، ويجب علينا دعوة عشرة
أشخاص صالحين ليطلبوا منهم الدعاء. هذه كلها نتائج الجهل بالإسلام. إكرام
الصالحين، دعوتهم، إطعامهم، تقديم الهدايا لهم، كلها أعمال صالحة مهمة. سيفعل
المؤمن هذه الأش حسب الاستطاعة والفرصة. ولكن الدعوة، والاحتفالات، والتجمعات من
أجل الدعاء للميت، كلها أفعال مخالفة للسنة. لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو أصحابه such things أبداً. وتقليدهم حرفياً هو
طريق النجاة وضمان الأجر.
في
الصدقة عن الميت، الطريقة السنية هي الوقف أو الصدقة الدائمة. التبرع الدائم بأرض،
أو منزل، أو جزء من منزل، أو مروحة، أو كتب، إلخ، للمسجد، أو المدرسة الدينية، أو
دار الأيتام، أو أي مؤسسة خيرية أخرى هو أفضل صدقة. نحن غالبًا ما نعتمد على
العادات المحلية لترتيب تقديم الطعام (الوليمة) أو 'الكولخاني'. هذه الطريقة في
الصدقة مخالفة للسنة. قد نتمكن من تقديم العديد من الحجج لصالحها. لو تبرع الصحابة
ببستان نخيل أو بئر، فما المانع إذا تبرعنا بوجبة 'برياني'؟ لكن سؤال المؤمن ليس
عن المانع، بل سؤال المؤمن هو: في أي شيء سيكون الثواب أكثر؟ إذا استطعنا اتباع
السنة، فما المانع؟ ورد في أحاديث لا تحصى أن الأعمال المخالفة للسنة لن يقبلها
الله أو لا يثيب عليها. فلماذا إذن نخالف السنة؟
دعونا نحلل قليلاً من حيث المزايا والعيوب. إذا أنفقنا مائة ألف تاكا على إقامة 'الذكرى الأربعين' أو 'الكولخاني'، فهناك احتمال كبير بعدم الحصول على الثواب بسبب مخالفة السنة. علاوة على ذلك، في مثل هذه المناسبات، تحدث النفاق والتحزبات، etc.، ويجب إطعام أشخاص قد يكون إطعامهم إثمًا. لهذه الأسباب، حتى لو حصل ثواب، فمن الطبيعي أن يكون قليلاً. والأهم من ذلك، إذا حصل بعض الثواب، فسيحدث ليوم واحد فقط، ولن يتكرر في اليوم التالي. ولكن إذا أنفقنا مائة ألف تاكا بالطريقة التي فعلها الصحابة، بالتبرع الدائم ببعض الأرض، أو الممتلكات، أو المال للمسجد، أو المدرسة، أو العمل الخيري، أو بالوقف الدائم لبئر أنبوبي للمسجد أو المدرسة، أو بئر ارتوازي لري مزارعي القرية أو لاستخدام عام، فهناك ضمان للثواب نتيجة اتباع الطريقة السنية. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعلم أن العمل وفق السنة يجلِب ثوابًا أكثر، ويمكن أن يصل إلى ثواب خمسين صحابيًا. لذلك يمكننا أن نتوقع ثوابًا أكبر بكثير من مائة ألف تاكا. والأهم من ذلك، أن ثواب هذا المبلغ من مائة ألف تاكا سيستمر في التراكم يوميًا في سجل أعمال والديك أو أحبائك، ولن تحتاج إلى التبرع مرة أخرى. أسأل الله العظيم أن يرضي قلوبنا بالسنة. آمين.
الكتاب: خطبة الإسلام
الدكتور خندقر عبدالله جهانجير راه..
কপিরাইট স্বত্ব © ২০২৫ আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট - সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত| Design & Developed By Biz IT BD
